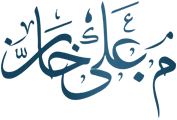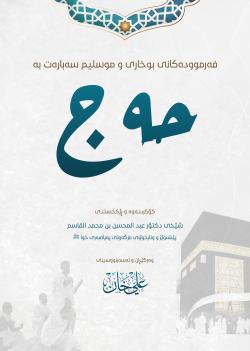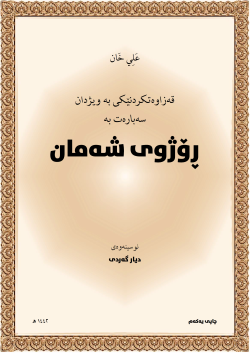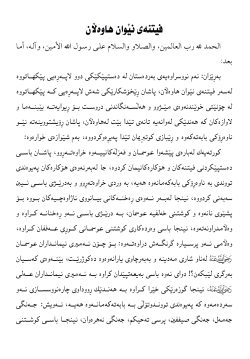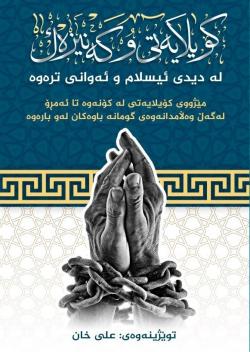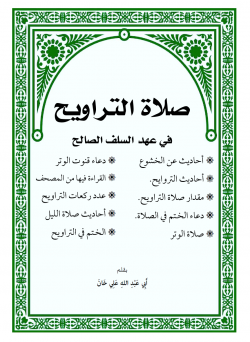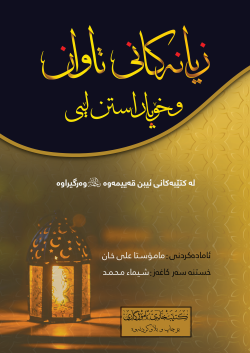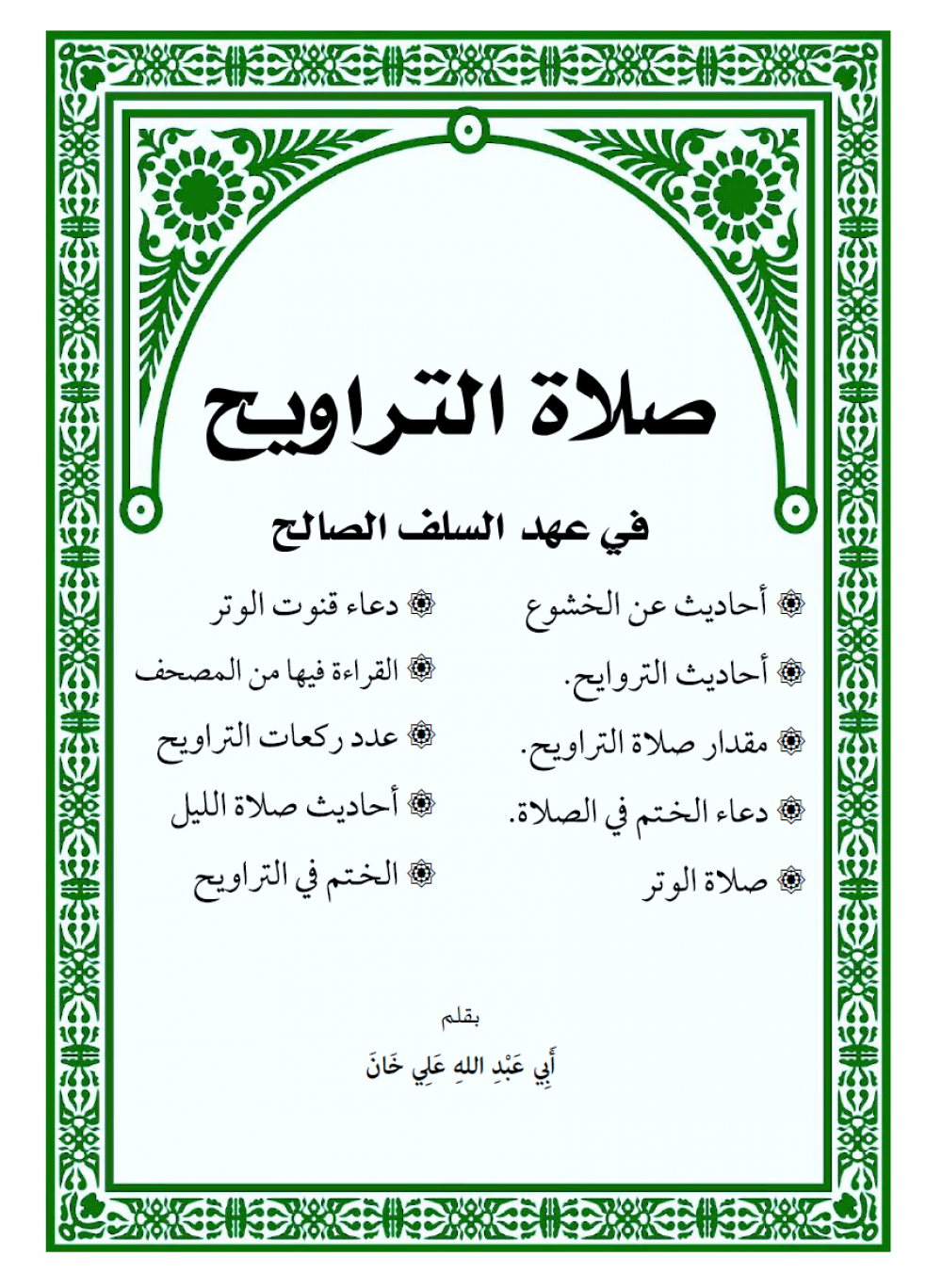
صلاة التراويح
في عهد السلف الصالح
* أحاديث عن الخشوع * أحاديث التروايح.
*مقدار صلاة التراويح. *دعاء الخـتم في الصلاة.
*صلاة الوتر * دعاء قنوت الوتر
*القراءة فيها من المصحف * دد ركعات التراويح
*أحاديث صلاة الليل * الخـتم في التراويح
بقلم
أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِي خَانَ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله حمد الشاكرين، وأستغفره استغفار المذنبين، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه، كما يحبّ ربّنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، اللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين، وصحبه الطيبين.
أيها القارئ الكريم، هذا البحث عبارة عن الأحاديث والآثار في مقدار صلاةِ النَّبِيِّ المُخْتَار صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخيار، من حيثُ الإطالةِ والاختصار، بعدما رأيتُ الاستنان والاقتداء بصلاته صلى الله عليه وسلم قد أُميتت، والناس لإحياءها قد أنكرت، بعضهم عدها بدعة، والآخر إثمًا، والثالث فتنةً، والرابع صاحبها جاهلًا، والخامس صلاته باطلةً! دون الرجوع إلى الأدلة، وأقوال الأئمة، حتى صار الخلاف فيها واضحًا، هل تجوز أو لا تجوز، مصداقًا لقول بعضهم([1]): «لَوْ سَكَتَ الجَاهِل أَوْ مَن لَا يَعلمُ لَسَقَطَ أو لَانْتَهى الاخْتِلافُ»، ولَعَلَّ الرَّجلَ يكون عالمًا في علمٍ من العلوم أو فنٍّ من الفنون، ولكنه في غيره جاهلًا، فينبغي له أن يسكت حتى لا يسقط، فكيف ببعض المخفِّفِين الذين ليسوا بطلاب العلم فضلًا عن أن يكونوا من أهله.
وعلى المتكلّم في هَذا الباب وغيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق، وغايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين، وإن جعل الحق تبعًا للهوى فسد القلب والعمل والحال والطَرِيْق، قَالَ الله تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون:71].
فالعلم والعدل: أصلُ كلّ خير، والظّلم والجهل: أصلُ كلّ شر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأمره أن يعدل بين الطوائف ولا يتبع هوى أحد منهم، فقَالَ تعالى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالِكمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [الشورى:15].
ولَا شَكَّ أَنَّ «الصَّلَاة خَيْرُ مَوْضُوعٍ»([2])، وأَفضَلُ عباداتِ البدَنِ، لما رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وثَوْبانُ، وأَبُو أُمَامَة رضي الله عنهم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ»([3])، ولأنّها تجمع من القُرب ما لا يجمع غيرها، من الطهارة، واستقبال القبلة، والقِراءة، وذكر الله جلَّ جلَاله، والصّلاة والسلام رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ويمنع فيها من كلّ ما يمنع منه في سائر العبادات، وتزيد عليها بالامتناع من الكلام، والمشي، وسائر الأفعال، وتطوّعها أفضل التطوّع ([4]).
قصة هذا الكتاب
وقصّة هَذا الكتاب أنّ هؤلاء المخفّفين قد أنكروا صلاةَ التراويح بأحد المساجد الذي كان إمامه يقرأ فيه -بداية أمره-: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، و﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ونحوها من السُّور، فانتشر بين النّاس أن المسجد الفلاني يُطيل الصّلاة، فصاروا يُشنّعون ويخطئون، وبعضهم حكم ببطلان صلاتهم كما بلغني.
فرأينا من الواجب علينا أنْ نقوم بإبراز ما أخفاها الأيام، ونشر ما طَواها، قبل أن يعَضّ على يديه مَن لا علم لديه، لقَفْوه فيما لا علم له به، فالهوى يصد المرء عن الهدى.
فقُمنا ببيان هديه وسنته صلى الله عليه وسلم في مقدار صلاته، في الفرائض وغيرها، ولْيقارِنوا همْ بين تراويحِهم التي هي سُنَّة، والأصل في التراويح جماعة التطويل([5])، وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض التي هم يقولون الأصل فيها التخفيف!
قَالَ ابن رجب رحمه الله -وما أحسن ما قاله!-([6]): «وقد كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يطيل القِرَاءَة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلّى معه حذيفة -أي: جماعةً- ليلةً في رمضان، قال: فقرأ بالبقرة ثم النّساء ثم آل عمران، لا يمرّ بآية تخويفٍ إلا وقف وسأل، فما صلّى الركعتين حتّى جاءه بلال فآذنه بالصلاة».
وكان عمر قد «أمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان. فكان القارىء يقرأ بالمائتين في ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصى من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر».
وفي رواية: «أنّهم كانوا يربطون الحبال بين السّواري ثم يتعلقون بها».
وروي «أَن عمر جمع ثلاثة قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس ثلاثين وأوسطهم بخمس وعشرين وأبطأهم بعشرين»، ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركعات. فإن قرأ بها في اثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف.
قَالَ ابن منصور: سئل إسحاق بن راهويه: كم يقرأ في قيام شهر رمضان؟ فلم يرخص في دون عشر آيات، فقيل له: إنهم لا يرضون؟ فقَالَ: لا رضوا، فلا تؤمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف، فبقدر عشر آيات من البقرة، يعني في كل ركعة...
وقد روي عن أبي ذر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل، وليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، فقَالَوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقَالَ: إن الرجل إذا صلى مع الإِمَام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته»([7])...» اهـ.
وقَالَ الأَلْبَانِيّ رحمه الله: «وأما القِرَاءَة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره، فلم يَحُدَّ فيها النبيّ صلى الله عليه وسلم حدًا لا يتعداه بزيادة أو نقص، بل كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فيها تختلف قصرًا وطولًا، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾، وهي عشرون آية، وتارة قدر خمسين آية، وكان يقول: «من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين».
وفي حديث آخر: «... بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين».
وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة -وهو مريض- السبع الطوال، وهي سورة ﴿البقرة﴾، و﴿آل عمران﴾، و﴿النساء﴾، و﴿المائدة﴾، و﴿الأنعام﴾، و﴿الأعراف﴾، و﴿التوبة﴾.
وفي قصّة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة ﴿البقرة﴾ ثم ﴿النساء﴾ ثم ﴿آل عمران﴾، وكان يقرؤها مترسلًا متمهلًا.
وثبت بأصحّ إِسْنَاد: «أن عمر رضي الله عنه لما أمر أُبّيَّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان، كان أُبيٌّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين، حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العِصِي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في أَوَائلِ الفجر».
وصحّ عن عمر أيضًا أنه دعا القُرَّاءَ في رمضان، «فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية، والوسط خمسًا وعشرين آية، والبطيء عشرين آية... «وخير الهدي هدي محمد»»([8]).
فينبغي لكل إمامٍ، ومنفرد، وكل مُصلٍّ أن يراعيَ هدْيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، القائل: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي»([9]). وقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِه مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِه؛ فَأَطِيلُوا الصَّلَاة، وَأَقْصِرُوا الخُطْبَة». ولا يترك الأمر لأهواء وشهوات المأمومين.
ورحم الله من أهدى إلي عيوبي، فأنا أعلن وأقول -غير متردد-: ما قلت من قول في هَذا الكتاب وغيره، خلاف ما قَالَه الله ورسوله أنا راجع عنه اللحظة، قبل وفاتي وبعد مماتي.
وحذفت التخريجات في هذا المختصر، فمن أراد الإطالة فليرجع إلى الأصل.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
علي خان
15رمضان 1433، بمسجد قاضي محمد
([1]) هذهِ المقولة المشهورة نسبت إلى سقراط «ت:399 ق.م»، وإلى الغزالي «ت:505هـ»، وإلى ابن الجوزي «ت:597هـ»، وليس لهما قطعًا لأن ابن عبد البر «ت:380هـ» ذكره في: «جامع بيان العلم وفضله» رقم (999) بدون سنَدٍ، وذِكْرٍ للقائل، وهو قبلهما بعشرات السنين... والله أعلم.
([2]) جزء من حديث أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (243) (بَاب الألف، من اسمه أَحْمَد، أَحْمَد بن محمد بن الحجاج المصري). وسنده ضعيف جدًا بلا شك، ولكن الشيخ الأَلْبَانِيّ أورده في «صحيح الترغيب والترعيب» (390)، وحسّنه لغيره بشواهده، وقد استوفينا الكلام على شواهده في الأصل، ولا قوة لها على تحسين الحديث بها، والله أعلم.
أما معناه فلا شك في صحّته، ولذا أوردناه دون نسبته إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم .
([3]) صحيح: حديث ثوبان؛ أخرجه ابن ماجه في «سننه» (277) (أبواب الطهارة وسننها، بَاب المحافظة على الوضوء)، والبيهقي في «سننه الكبير» (374، 2174) (كتاب الطهارة، بَاب فضيلة الوضوء)، وأَحْمَد في «مسنده» (22812، 22849...) (مسند الأنصار v، ومن حديث ثوبان c)، وابن حبان في «صحيحه» (1037) (كتاب الطهارة، ذكر إثبات الإيمان للمحافظ على الوضوء)، والحاكم في «مستدركه» (446، 447، 448) (كتاب الطهارة، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)، والدارمي في «مسنده» (681، 682) (كتاب الطهارة، بَاب ما جاء فِي الطهور)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (1444) (بَاب الثاء، من غرائب مسند ثوبان.
قَالَ الحاكم: «هَذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَسْتُ أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً يُعَلَّلُ بِمِثْلِهَا مِثْلَ هَذا الْحَدِيثِ، إِلَّا وَهْمٌ مِنْ أَبِي بِلَالٍ الْأَشْعَرِيِّ، وَهِمَ فِيهِ عَلَى أَبِي مُعَاوِيَةَ» اهـ.
ووافقه الذهبي، وكذا المنذرى فى «الترغيب» بقوله: «رواه ابن ماجه بإِسْنَاد صحيح» اهـ.
وقَالَ البوصيري: «ورجال إِسْنَاده ثقات أثبات».
وفيه انقظاع بين سالم وثوبان، «ولكن أخرجه الدارمى، وابن حبان من طَرِيْق ثوبان متصلًا». أفاده البوصيري.
وللطرق والروايات الأخرى؛ انظر: «إرواء الغليل» (412) (2/135).
بۆ دابهزاندن
- زەخیرەکردن
- 5 ساڵ لەمەوپێش
- 8310 جار بینراوە